"العوْدوماتية"، ومنهج إستقصائي لفقه اللغات.
الهندو-أوروبية هو مصطلح تم اختراعه لقطع صلة اللغات الاوروبية باللغة العربية ولهجاتها الكثيرة وذلك بهدف الاستحواذ على تاريخ عريق واخفاء جذور ذلك التاريخ الممتدة في بلاد العرب. أديانهم من هذه البلاد وعلومهم وأساطيرهم وفلسفاتهم ولغاتهم ايضاً.
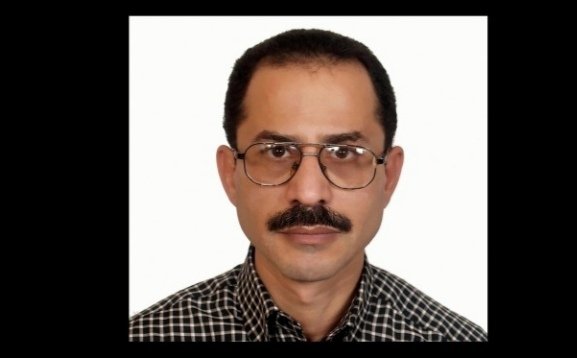
يمكن للقاريء غير الضليع باللغات وتاريخها تخطي الفقرات التي تبدو صعبة أو معقدة، وهذا لن يؤثر على المعنى العام لهذه المقالة، فهذه ليست دراسة مفصلة ولكنها تهدف إلى ايصال فكرة عامة مع بعض الغوص الذي قد يهتم به أهل الاختصاص.
ورد في كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق - الشريف الادريسي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٢ جملة أثارت إنتباهي يقول فيها:
"وعمل الأفطي ماطي وتفسيره الأذن والعين وفيه حصون ثلاثة ومدينة نقموذية وهي الآن خراب".
"نقموذية" هو إسم مدينة كانت في الأناضول، وكلمة "عمل" تأتي هنا بمعنى ولاية أو مقاطعة أو محافظة.
وما شد انتباهي هو إسم هذه الولاية "أفطي ماطي" وقربها من كلمة اوتوماتيك (automatic) بالإنجليزية أو أفتامات (автомат) بالروسية، فهل هو مجرد تشابه لفظي أم أن المعنى هو حقاً كذلك؟
وتفسير الإدريسي للإسم بمعنى الأذن والعين بدا لي غريباً، فما هي تلك اللغة؟ وهكذا ذهبت أجوْجل في الشبكة العنكبوتية عن تاريخ الكلمة وأصولها.
بحسب اللغة الإنجليزية المعاصرة جائت معاني
أوتوماتيكي كالتالي على موقع:
https://www.etymonline.com/word/automatic#etymonline_v_26762
والترجمة تتبع النص الأجنبي ادناه، يليها تلخيص الترجمة لمن لا يود الغوص في تفاصيل قاموسية،
"self-acting, moving or acting on its own," 1812 (automatical is from 1580s; automatous from 1640s), from Greek automatos of persons "acting of one's own will;" of things "self-moving, self-acting," used of the gates of Olympus and the tripods of Hephaestus (also "without apparent cause, by accident"), from autos "self" (see auto-) + matos "thinking, animated," *men- (1) "to think."
وترجمة ذلك مع ترقيم البنود:
١- تعمل ذاتيًا - تتحرك أو تعمل من تلقاء نفسها" ، 1812
٢- ( -أوتوماتيكال- automatical من ثمانينيات القرن الخامس عشر ؛ automatous -أتوماتوس- من أربعينيات القرن السادس عشر)،
٣- من اليونانية automatos -أتوماتوس- للأشخاص "يتصرفون بإرادتهم" ؛ للأشياء "ذاتية الحركة ، ذاتية الفعل"،
٤- استخدمت لبوابات الأوليمبوس ولطاولات هيفايستوس ثلاثية الأرجل
٥- (أيضًا "بدون سبب واضح ، بالصدفة")،
٦- من autos -أوتوس- "الذات" (انظر -auto -أوتو-) + matos -ماتوس- "التفكير ، التحريك،" men- (1)* "يفكر".
وتلخيص ما ورد أن معنى الكلمة هو عمل ينطلق من الذات أو النفس وبالإرادة وبالصدفة، ثم أخيراً قسمت الكلمة إلى جزئين، الأول يرتبط بالذات أو النفس والثاني بالتفكير.
في كل ذلك لم اعثر على الغاية التي ذهب إليها الإدريسي، أي تفسير الكلمة بمعنى الأذن والعين.
ولما نصحني كاتب القاموس ب (see auto) ذهبت لأرى فوجدت التسلسل التاريخي للكلمة وصولاً إلى ما قبل الهندو-أوروبية وساختصر ذلك التسلسل بالمفيد:
auto - autus - auctus - augeo -
Proto-Indo-European/h₂ewg-
ومعناها to increase, to enlarge، اي يكبِّر أو يزيد.
ولم أجد في هذا إلا زيادة في غموض المسألة. فلا وجود أي ذكر للذات أو النفس أو الإرادة والصدفة والتفكير، التفسير هنا مختلف كلياً عن ما سبق.
وللإيضاح، حرف "h" الوارد في "h₂ewg" اختفى نطقه في اللغات ذات الأصول الهند-أوروبية وهو في الأصل حرف الهاء ينطق مخففاً وما زال الهنود ينطقونه بهذا الشكل المخفف. مثلاً، كلمة "auto" كانت في الأصل "hauto"، كما يقولون. مازلنا نلاحظ وجود هذا الحرف الغير منطوق في كلمات انكليزية مثل what وwhere.
ولأن الإدريسي ربط الكلمة بالأذن بحثت في كلمة أخرى لها علاقة بالأذن وتشبه لفظ "أفطي":
audio
Proto-Italic *awizdjō, a compound of Proto-Indo-European *h₂ewis (“clearly, manifestly”) (from the root *h₂ew- (“to see, perceive”)) and *dʰh₁-ye/o- (“to render”).
بحسب ما ورد في القاموس، كلمة "audio" تتحدث عن الرؤية التي تحدث من خلال العين ولا علاقة لذلك بالأذن والصوت، وأيضاً تتحدث عن التلقي، مثلما تتحدث عن الإعلان الفصيح عن الشيء. لا يوجد ولو رائحة ولو من بعيد لكلمة self (ذاتي أو نفس)؛ بينما المشترك بين الكلمتين auto وaudio هو الجذر الهندو-أوروبي "h₂ew" وقراءته بالانكليزية "أوٰ" (au) وبالروسية "أف" (ав) ويفيد بحسب تقديري معنى التلقي لفعل ما، وهو من المعاني التي اوردها القاموس أعلاه في معنى audio.
عفواً.. لحظة...
هل قلت "التلقي" لفعل ما؟
طبعاً، لأن العرب يترجمون كلمة "أوتوماتيكي" إلى كلمة "تلقائي" وهذا ليس صدفة، بل لأنهم ينقلون المعنى بدقة وبشكل "تلقائي" و بدون الحاجة إلى جذور هندو-اوروبية. وهذه ليست عصبية أو عنصرية بل نظرة موضوعية.
لم أخضع لليأس وجوْجلت الكلمة الاغريقية
αὐτός • (autós)
والنتيجة بمختصر مفيد:
Proto-Indo-European *h₂ew (“again”) + *to- (“that”).
ولا أدري لماذا اقحمت كلمة "self" في الشرح اللاحق لمعنى الكلمة مرة أخرى وفي هذا المصدر ايضاً، فالمعنى هنا واضح، "ذلك مرة أخرى" وهذا بالضبط ما نريد وما يكفي.
مع كل هذه المتاهات رأيت أن أجرب البحث باللغة العربية عما يشبه audio فوصلت إلى كلمة لم أسمع ذكرها من قبل هي كلمة "أود" تحت مصدر "آد"... يقال أوَد العود أو أوِد العود اي إعوجّ العود.
ومعلوم أن العرب كانوا ومازالوا يستبدلون الأحرف بحسب لهجاتهم، فكلمة إعوجّ إذا ما استبدلت جيمها بالدال تصبح إعودّ، وكلمة أود قد تصبح عوَدَ أو عَوَج (أنظر جذر h₂ewg أعلاه) إذا ما استبدلنا الهمزة بالعين، وهكذا حتى نصل إلى أودِيْو (audio) التي تصبح "عَوْديو" (الواو في نهاية الكلمة بمثابة حركة الضم بالكتابة العربية المعاصرة) وهذا يطابق تفسير "ذلك مرة أخرى" آنف الذكر، بمعنى الإعادة بحسب تعبيرنا الحديث، ذلك لأن حرف الدال قابل للتبديل مع حرف التاء فتصبح autio مثيلة لِ audio.
بكلام آخر كلمة auto بتعريب الكتابة تصبح "عَوْتو" وهي كلمة حرفت عن "عَوْدو" (audo) خلال أو قبل انتقالها إلى الاغريقية أو اللاتينية. والتنوين كان قديماً بحرف الميم بدل النون، لذلك فكلمة عَوْدٌ (عَوْدُن) كانت تقرأ عوْدُم (audom) باللهجات الشامية القديمة التي منها إنتقلت الكلمات إلى اليونانية. ومثال ذلك كلمة" أكاديٌ" (أكاديُن) التي تنطق باللهجة الأكدية "أكاديم"، وبها مازالت تتسمى وتفخر "أكاديميات" العلوم في أنحاء الأرض.
وإذا أضفنا تاء التأنيث على عودُم تصبح عوْدُمة. وبقراءة غير العرب عودمة تلفظ عوْدومات، وسنحصل على نفس اللفظ لو جمعناها جمع تأنيث، وهي كلمة تقابل بالتمام كلمة automat بعد إبدال الدال بالتاء. ثم إذا أضفنا إليها ياء النسبة تصبح عوْدوماتي، ومعناها الشيء الذي يعاود العمل مرة بعد مرة أي يكرره. ومثيل ذلك في لهجتنا المعاصرة من حيث الدلالة والمفهوم كلمة "عيادة" لوصف المكان الذي تتكرر زيارات المرضى اليه، وكلمة "عادة" لوصف الفعل الذي يكرره الإنسان بشكل "تلقائي".
إن مثل هذا التركيب اللغوي لكلمة "عودوماتي" قد لا نلاحظه في كلام ولهجات العرب، سواءٌ حديثهم أو قديمهم، ذلك لأنه تركيب أعجمي لا يفي بقواعد اللفظ العربي من حيث إزالة نون (أو ميم) التنوين إذا تبعته لاحقة ما. فالجامعات توصف بالعربية بأنها "أكادية" وليس "أكاديمية". وبالخروج قليلاً عن الموضوع الراهن، فقدموس أو "كاديموس" بحسب الأسطورة الإغريقية قد يقصد بها "الأكادي" (الأكاديمي) وليس القديم أو القادم، فهو من علم تلك البلاد الكتابة بأحرف كنعانية.
وليس بالضرورة أن تدل نهاية الكلمة بالألف والتاء على التأنيث بل يمكن أن تدل على الحرفة أو المهنة التي يداوم عليها شخص ما، مثل حكواتي ومسحراتي وجنيناتي.
وبالعودة إلى الإدريسي، فهو لم يخطيء بتفسير الأفطي ماطي بالأذن والعين، فها هي قواميس أوروبا تربط كلمة audio المرتبطة بالمسموعات بحسب فهمنا الحديث للكلمة، تربطها بالمرئيات كما ورد أعلاه
*h₂ew- (“to see, perceive”).
ومعناها (يرى، يتلقى). أي أن مدلول الكلمة مرتبط بالتلقي سواء بالعين أو بالأذن أو غير ذلك. وهذا المدلول لا يبعدنا عن المنطق، لأن كل شيء إذا ما "عاد" إلينا فنحن نتلقاه. هكذا يكون الترابط بواسطة المدلول وليس بواسطة اللفظ. والعرب عندما يقولون عين الشيء يقصدون ذاته.
وبالعودة إلى حرف h₂ في مقطع "h₂ew" في ما يسمى بالهندو-أوروبية الأم، فلأن الاعاجم لا ينطقون بعض الأحرف العربية يلتبس أمرها عليهم ويقربونها إلى الأحرف المنطوقة لديهم. لهذا السبب نرى لديهم أحرف مرقمة وهذا يعني أنها أحرف مختلفة تم تقريبها إلى حرف واحد من أحرفهم. وهنا لا بد أن يكون المقصود بِ h₂ حرف العين وليس حرف الهاء. وبما أن الهنود من الاعاجم ايضاً فهم لا ينطقون حرف العين ولكن يميزونه عن حرف الهاء بالتخفيف بلفظه.
أما من حيث الجغرافيا، الأفطي ماطي هي مقاطعة من بلاد الروم لا غزو فيها لبعدها عن الخصوم، لها شواطيء على البحر الأسود وعلى بحر مرمرة في الجزء الآسيوي من دولة تركيا الحالية، أي أنها تقابل مدينة القسطنطينية عبر المضيق. هذا الموقع يجعل من المقاطعة محطة ومعبراً للتجارة والسفر نحو الجزء الأوروبي ذهاباً واياباً على التكرار ولربما هذا ما أكسبها إسم افطي ماطي.
والآن لنربط كل ذلك مع علومنا الحديثة، فالآلات "الأوتوماتيكية" (العوْدوماتية) تعيد وتكرر الأعمال التي لقنت بها من قبل، والإعادة محكومة بالتلقين (البرمجة) الذي تلقته الآلة من قبل، فإن وصفنا الآلة بالأعادة والتكرار فهذا صحيح، وإن وصفناها بتلقي التلقينات (العين والأذن) فهذا ايضاً صحيح. وإن جعلنا مصدر التلقين في داخل الآلة ليكون جزءاً منها يصبح التلقين ذاتياً من نفسها. من هنا منبع الجدل في فقه الكلمة وفقه اللغة بشكل عام.
تتغير معاني الكلمات عبر التاريخ ويدخل فيها إجتهاد اللغوين فتضيع أصول المعاني والمنطق الذي يربط بينها، ذلك لأن من طبع الإنسان الاختزال والإختصار وبالتالي إهمال جوانب عديدة من شأنها أن ترفد علم التاريخ بمعلومات ومدد ذو قيمة.
الجدل لا ينتهي عند هذا الحد، بل ما زال فيه فروع متفرعة.
حسام شعبان
