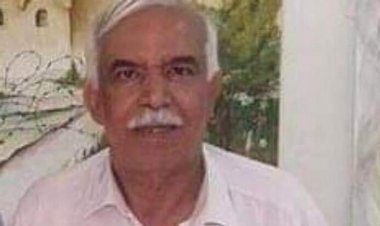يوسف سامي اليوسف : رعشة الروح
يكون من المحال ملاحقة التحوّلات الجماليّة التي قبضت عليها الممارسة التنظيريّة والنقديّة في مجرى الانزياحات الشعريّة الّتي اجترحتها الممارسة الشعريّة خاصّة ، والأدبيّة عامّة

في ذكرى رحيل كبير النقاد يوسف سامي اليوسف :
يكون من المحال ملاحقة التحوّلات الجماليّة التي قبضت عليها الممارسة التنظيريّة والنقديّة في مجرى الانزياحات الشعريّة الّتي اجترحتها الممارسة الشعريّة خاصّة ، والأدبيّة عامّة ، دون قراءة عميقة تتوسّل الإضافات الخصوصيّة الّتي قدمها الناقد الفلسطيني يوسف سامي اليوسف ، ممارسةً تنظيريّة ونقديّة ، تصوّراتٍ ورؤى ، ومعايير نقديّة تربط الفاعليّة الجماليّة بالفعل الإبداعيّ ،وأثره في تكوين متلازمة القيمة والفنّ بوصفهما حدّين للإبداع العظيم . وربّما يكون ذلك كلّه أحد الدوافع الّتي أهالت عليه أوصافاً كثيرة ، منها كبير النقّاد .
ولا شكّ أن ثقافته الموسوعيّة هي الّتي حصّنت مختبره النقديّ، الفكريّ ليخلق ذاته بذاته مكتفياً بمحاكمات يتقدّم بها معياره الخصوصيّ عبر تأويل المحدَث ، المضيء في التراث النقديّ، الفكريّ العربيّ ، ربطاً بالفعل الحداثيّ المعاصر . وهكذا تتكثّف في رؤاه تصوّرات النفريّ والقاضي الجرجاني ، وتجليّات بن عربي ، وقراءات الآمديّ وسواهم ، لتتجاور مع منجزات النقد الحديث المعاصر ، ما يشي بأنّ الفعل الحداثيّ الذي يتبنّاه اليوسف ، ناقداً ومفكّراً ، لا يستقيم مع أطروحات حداثييّن رأوا أن متن الحداثة هي إعلان الطلاق مع العالم القديم ، بأشكاله المألوفة والتصوّرات الّتي أنتجتها .
فمنذ كتابه " مقالات في الشعر الجاهليّ "(1975) مروراً بمؤلفه " بحوث في المعلّقات " (1978) حتّى " الشعر العربيّ المعاصر" (1980) و" ما الشعر العظيم؟" (1981) تتجلّى آراؤه النقديّة مجسّدة ، في أساسها، على ثنائيّة الروح والذوق ، وفي هذا إعلاء لشأن مقولات أصحاب العقل في التراث العربيّ ، الأمر الّذي تبدّى واضح المعالم في مؤلفه " القيمة والمعيار" (2000).
غير أنّ الروح والذوق لا يمكن أن يكونا كتلتين قائمتين بذاتيهما، بالقدر الّذي تشكّلان عنصرين أساسيّين في عمليّتي القراءة والكتابة معاً ، طالما أنّ الروح الشعريّ الخصوصيّ في لحظة الكتابة ، كتابة نفسه بوصفه شخصيّة إبداعيّة، يتقدّم في النصّ الإبداعي بتقديم ذوق خصوصيّ وهو يخلق العالم اللغة . اللغة ذاتها الّتي تصبح في عملية الخلق الإبداعيّ مبنى ومعنى النصّ المقدّم ، تجلّيه وتأويله، إعادة كتابته وقراءته معاً ، في لحظة الكتابة ولحظة القراءة ، وهذا ما يجعل عنصر الإلهام الّذي يراه اليوسف صنو العبقريّة مرتبطاً بفعل التلقّي نفسه لدى القراءة . وهكذا يصبح المبدع والقارئ شريكين في كتابة وقراءة النصّ الإبداعيّ. وأعتقد أن هذا أصل الشعر العظيم .
غير أنّ هذا كلّه ، لا يتضح في منهج اليوسف إلا بخوض مغامرة تفكيك مقولاته ، وإعادة بنائها .
لكنّه ، لا شكّ، قدّم مشروعاً نقديّاً ، جماليّاً، تقدّم على عصره بحساسيّته الخصوصيّة وثقافته عالية الذائقة . ولعلّ هذا ما قيّض له أن يختلف مع الآخرين من النقاد الّذين انشغلوا بالقراءات باشتغاله على ممارسة نقديّة تقترب من التنظيريّة ، وجعل النقد يحتضن لغة جماليّة تكاد تقترب من أن تكون لغة طازجة تحاكي النصوص الأدبيّة عالية الحساسيّة . وهكذا يكاد يكون بما كتب من نقد ، كمن كتب أدباً عن أدب ، فغدت قراءاته إعادة صياغة للأدب المقروء، معالجة وتحليلاً.
ولأنّه كان موقناً أنّ الشعر ديوان العرب ، وربما لأنّه أيقن ، بحذاقة الناقد وحنكة العارف، أنّ الرواية العربيّة لم ترق لمحاكاة الروايات العالميّة ، ظلّت تراوده مغامرة حياكة رؤيا نقديّة عن الشعر بوصفه مشروعاً جماليّاً للروح والذوق العربي ، قديماً ومعاصراً، قيمة وفاعليّة ، وكذلك بوصفه حالة تكثيف للظواهر والهواجس الّتي تطبع عالميه ، الداخليّ والخارجيّ ، متّكئاً على أفكار ومقولات فلاسفة وعلماء نفس ، عرباً وأوربيّين ، للعناية بالذات الشاعرة ومنجزها المبدَع ، انطلاقا من سلوك الروح المبدِع وبصمات الذوق المقدّم . وبهذا لا يكون الشعر عظيماً ، كما يقدّم ، إلا إذا كان منطلقاً من روح عظيمة ونفس توّاقة للسموّ والكمال، أي تخلق قيماً عظيمة .
إن إقامة اليوسف في الشعر العربيّ القديم لا تعني مكوثه في الماضي ، حال قراءته للشعر الجاهليّ والعذريّ ، سيما وأنّه وشى أو أراد أن يشي بالتعاطي مع الجاهليّ مقاربة بالشعر العالميّ الكلاسيكيّ ، وقارن العذريّ بالرومانسيّ الغربيّ، مثالاً لا حصراً ، بل تغدو بمثابة هجرة عبر محاكماته للشعر المعاصر لاقتناص التحوّلات الحقيقيّة الّتي اقترفها الروح الشاعر بقيمه الذوقيّة الإنسانيّة الساعية للسموّ والكمال ، كما أسلفنا.
فالماضي الشعريّ ، وفق فهمه، يحمل إضاءات تمكّن أدوات البحث النقديّ المعاصر من التقاط الانزياحات الجوهريّة في الشعر المعاصر .
وهكذا ، لا يبدو الماضي الشعريّ في رؤيته بعداً تاريخيّاً قائماً بذاته، بل إقامة الروح في رؤى عالمها الراهن ، الرؤى ذاتها الّتي تخلق هذا العالم انطلاقاً من المضيء في صورته القديمة . فالروح الشعريّ القديم ما يزال يجسّد حلوله في المعاصر ، حسب ظنّه .
وفي هذا افتراق جوهريّ عن دعوات مجددّين أو حداثيّين عرب رأوا أنّ الحداثة لا تستقيم إلا بكسر عمود الشعر والعالم القديمين ، أي القطيعة مع الشعر القديم والتصورات الّتي أنتجته .
كما أن تصدّي اليوسف لقراءة الشعر المعاصر لم تكن بعيدة عن محاكمة الظواهر والتحولات الوجوديّة ، فالشعر العظيم هو رعشة الروح الكبرى في بحثها عن حضورها في اللغة والعالم ، كما يمكن استخلاصه من مؤلفاته الّتي عنيت بالممارسة الشعريّة مثل " الخيال والحريّة "(2001)، و" الشعر والحساسيّة"(2010)، و" الأسلوب والأدب والقيمة" (2011)، حيث يقترح معايير جديدة لنقد الإبداع ، وأدوات الحكم على القيمة الإبداعيّة، واعتبار عمليّة التخييل البيت الحرّ الّذي على المبدع أن يقيم فيه ، طالما يصبح الخيال مناخ الحريّة الوحيد الّذي يتنفّس فيه .
فيما يتجاوز أفكاراً ومقولات في " القيمة والمعيار" (2000) ليتصدّى لخلق تحديدات ومفاهيم تعنى بها الممارسة التنظيريّة ، مصطلحاً ومعياراً ، بما في ذلك لدى تصدّيه لفنّ السرد القصصيّ والروائيّ، كما في " مقال في الرواية" (2002) سعياً لكتابة رواية عربيّة تنزع عنها معطف الرواية العالميّة بكتابة ذاتها .
أمراً يمكن العثور عليه في " غسان كنفاني رعشة المأساة " (1985).
ولعلّ قراءتيه لأدب غسّان كنفانيّ وسميرة عزام في " الشخصية والقيمة والأسلوب " (1985) مجوهرتان في التوكيد على أنّ الأدب العظيم هو نتاج لرعشة الروح الباحث عن حضوره الأبديّ انطلاقاً من تحوّلات الراهن المعاش ، حيث تصبح الذات المبدعة أصل العالم ، ومتن اللغة الّتي تخلقه كقيمة إنسانيّة كبرى، وهو ما سوف يتبدّى لاحقاً في " تلك الأيام " حيث تصوغ ذاته الّتي تتذكّر لتشهد على رعشة روحها في تغريبتها الكبرى منذ عام 1984 ، بزلزلة الاقتلاع وانكسارات اللجوء وآلام المجازر، إلخ . وهكذا يغدو المضي في درب الألم وصناعة الجمال رعشة الروح الحاضر في تاريخه ليجسّد أسطورته ، معجزته ، في خلق الحبّ للانتصار على الموت . وكذلك في " دمشق الّتي عايشتها" (2008)، حيث يرصد تجليّات الروح في علاقتها بالمكان ، ويمضي معه نحو زمن يكسر فيه العلاقة التقليديّة بالأشياء والتفاصيل والحيوات ، ليختصرها في الذات الباحثة في زمن الذاكرة عن مكوث في الأزليّ ، المجهول ، الملتبس ، ربطاً بعلاقة وجوديّة تعلي من شأن المكان الّذي احتضنه في تغريبة الروح ، روحه -الرعشة الكبرى .
وبهذا يتكوكب انتماء الروح لرعشتها، بما هي ، أو هما، رواية الذات المبدعة الّتي أخرجت ذاتها من أسفار التاريخ ، الماضي، لتجسّد حضورها في إقامتها بالزمن الراهن، وحركتها الدائمة لولوج المستقبل ، الأبديّ.
وهكذا لايغدو " تاريخ فلسطين عبر العصور" ( 1989) و " الغيتو الصهيونيّ"(2006) خطاباً ممهوراً بشعار تقليديّ يسعى لتفكيك سرديّة المحتلّ ، بالقدر الّذي يسعى لكتابة رواية الذات في مواجهة شرعة الإسرائيليّ القائمة على المحو والإلغاء . وهنا تتجلّى روح المفكّر اليوسف ، حيث يتقدّم الانتماء كقيمة تسعى للسموّ الكونيّ، وتقدم الروح الفلسطينيّ كرعشة مأساة كونيّة .
أما في اقتراحاته الّتي يصوغها في " مقدّمة للنفريّ" (1997)الّذي كسرالمسافة الّتي ظلّت قائمة في الموروث العربيّ بين كلام شعريّ وآخر نثريّ ، فإنّه يتجاوز نظرة المحدِثين بأنّ قصيدة النثر ينبغي لها كي تكمل خلاصها من منجزات الشعريّة العربيةّ أن تخلق لغتها النثريّة وأدواتها الخاصّة .
وبما امتلك الروح المتوقّد من معاناة يعيد قراءة تجلّي الروح المتصوّف كما في " مقالات صوفية" (2007)، و" ابن الفارض " (1994)أيضاً ، بحيث يجعل الذات في حلولها بعالمها الطاقة الأصل للإبداع ، واللغة بداية ونهاية الذات - الروح الخالق للعالم، والعالم المخلوق المتجدّد دوماً . لا ينتهي كلّ منهما ، أو كلاهما، إلا ليبدأ ، أو يبدآ .
وبذات الروح المتوهّجة يخوض اليوسف مغامرة ترجمة مختارات ت . س . إليوت (1986) بعد أن قام بترجمته مبدعون عرب كبار، ليؤكّد مقدرته الخصوصيّة على تقديم ما قُدّم بخلق جديد يطمح لتجاوز المنجَز والمألوف .
وفي هذه المؤلفات ، وسواها والّتي تحتاج قراءات معمّقة ، يظلّ يوسف سامي اليوسف ناقداً ومفكّراً شموليّاً ، يحتاج تراثه إلى دراسات اكاديميّة للوقوف على ما أنجزته من جديد وخلاّق.
هامش لا بدّ منه :
لم يقيّض لي قدري أن التقي بالناقد الكبير يوسف سامي اليوسف أبي الوليد كثيراً، فقد سافرت إلى موسكو نهاية ثمانينيّات القرن الماضي . لكنّ لقاءنا الأوّل في بيته في شارع الجاعونة في مخيّم اليرموك كان أشبه بتعجلّي غدي أن يجيء. كان الكاتب الراحل أحمد السرساوي الّذي صاحبني في الطريق إليه ولقائي معه ، قد أخبرني أنّ أبا الوليد الّذي قرأ لي قصيدة كنت نشرتها في مجلّة الحريّة امتدح شعري ، وبالكاد يفعل ذلك إلا نادراً ، فالرجل يحتفظ لنفسه بمعايير خاصّة تجعل اعترافه بشاعر ما ، سيما شاب مثلي ، وقد كان عمري آنذاك يكاد ينوف بقليلٍ عشرين عاماً ، أشبه بعثوره على مخطوطة نادرة . رحّب بي بما يليق به ، وأستحقّ كضيف يزوره لأوّل مرّة . و بكثافة العبقريّة ولغة التجلّي أبدى رأيه فيما كتبت . وكأنه قال : يعجبني الشاعر الّذي يحيي اللغة ليقطن فيها ، وكأنني قلت له : أنا أعيش في قصيدتي .
ولم يتأخّر في الاستجابة لطلبي ، بأنّ خصّ العدد الأوّل من مجلّة الغد الجديد ، وهي أوّل مجلة فلسطينيّة شبابيّة ، الّتي تفرّغت في المنظمة للإشراف عليها وتحويلها من جريدة عاديّة إلى مجلّة شهريّة فكريّة ثقافيّة ، بمقالة لم تنشر من قبل . يا لعظمة التواضع !.
كان حديثه عن الشعر والأدب والثقافة عموماً ، وهذا ما تلمّسته في لقاءات أخرى قليلة ، لا يشبه أحاديث نقاد آخرين عرفت في دمشق وسواها. وكأنّ أحداً ما لا يتحدث بتلك اللغة الّتي ينطق بها أفكاراً ورؤى محمولة على أجنحة تجعلك تتنفّس بخبطها في الأنحاء والأبعاد. وكثيراً ما بدا وكأنّه يلقّن بحماسة من يريد للإبداع أن ينقذ العالم بخلق الجمال وترسيخ القيم والأخلاق . وكأنّ الروح والعالم ، يسكنان في كلامه كوصايا تتطهّر بها الذات عمّن سواها ، وعمّا سواها أيضاً ، من وزر خطيئتها.
لقد كان الرجل أكثر من ناقد ، وأبعد من مفكّر ، وأكبر من وصفه بفكرة واحدة . إنه باختصار يوسف سامي اليوسف أبو الوليد الّذي ترك إرثاً كبيراً شكّل إضافة في المشهد الثقافيّ الفلسطينيّ والعربيّ ، تستحق القراءة والتأمّل العميقين .
د. عبدالله عيسى