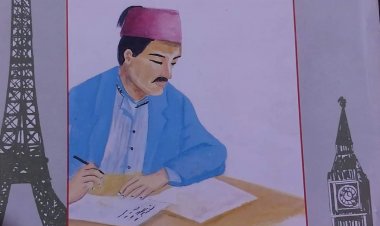جدارٌ من الماءِ - قصيدة جديدة للشاعر الفلسطيني عبد الله عيسى

يا إلهي الّذي خصّني بالرضا!
كثرتْ حِنطتي وخِرافي، وأهديتُ حقلاً وبئرينِ
للعابرين إليّ بألسنةٍ ولحىً ما عهدتُ بها قبلَ هذا.
ولكنّهم كسَروا في طريقِ الغديرِ جرارَ ابنتي،
وعلى غفلةٍ من يديْ،
سرقوا عسلي وحليبي، فماذا
أقولُ لزوجي التي حملتْ برسولِكَ
كي يهتدي بِعَصَاهُ العُصاةُ،
ويصغي القضاةُ إلى ساكنيْ السمَواتِ؟
بنيتُ المدينةَ عاليةً فوق أعلى الهضابِ
لتصبحَ أرضُكَ أقربَ منكَ إليكَ،
وأقبلتُ أطعمُ خبزي وأسقي خموريَ
من دخلوا مَعبدي لكي يطمئنّوا لمُعجزتيْ
أنّني صاحبُ البئرِ،
والحَجَراتِ الثلاثِ التي تسْندُ القِدْرَ،
والنارَ بين خيام شعوبٍ تقلّدُني في الأساطيرِ.
مَنْ أكملَ الأنبياءُ الرسالاتِ بين يديهِ،
ويتبعُهُ المُرسَلونَ كماءِ الينابيع ِ
يَجْدِفُ مستبشراً في مجاري السُهولِ البعيدةِ،
والآثمونَ إذا قنطوا ما حجبتُ يدَ الربّ عنهمْ،
ولا وجهَهُ،
والّذينَ يُسَرّ بهم كلّما ذكَرُوا آيتي،
فأضأتُ سَراجاً منيراً لهمْ
في البلاد الّتي أطفأتْ نارَها جمَراتُ حروبِ الطوائفِ،
أو في المحيطاتِ مذْ أعمتِ الظلُماتُ مناراتِها،
ووهبتُ المغنّينَ كلّ المزاميرِ
حتّى ترِقّ قلوبُ الّذينَ طغَوا
في القُرى والمنافي.
2-
ذلك البربريّ الّذي جاءنا من وراءِ البحارِ
بأسلحةٍ لا ترانا سوى جثثٍ
تتأوّهُ في ذاكراتِ ِالّذين نجوا من حديثِ المجازرِ،
أحرَقَ حقلاً من القمح
حتّى يدرّبَ أحفادَهُ الضجِرينَ على رَمْيِ فزّاعةٍ بالرصاصِ،
وأخمدَ بالنارِ ضوءَ المنارةِ
كي لا تعودَ بمَنْ عبرُوا مثلهُ السفنُ التي أحرقوها،
ولم ينتبهْ لأنينِ يدِ المعمدان التي بتروها على ضفّةِ النهر ِ،
أو سمكٍ يتعفّنُ تحت ثيابِ الرُواةِ،
رأوه يقلّدُ صورتَهُ في الأساطيرِ:
يبكي على حجَرٍ في حدائقِ بابلَ
حريّتي طعمُ موتي المؤجّل،
سوف تهبّ مع الريحِ
حين تعود الظلالُ الّتي فقدتْها،
على حائطٍ جرَفتْهُ الزلازلُ،
أشباحُنا،
شاهدوه يعلّقُ صورتَهُ في متاحف ِ قتلى شعوبٍ
تراني ضحيّتَهُ في مراياهُ:
يرقصُ فوق أريكةِ جدّي التي تتألّمُ
فوقَ سلالمِ بيتِ السلالةِ غير المُضاءةِ.
حرّيتي أن أؤجّلَ موتي كما أشتهي،
أنّني اخترتُ ربّي لكي يصطفيني على من سوايَ،
أمجدّه، فيظلّ خلاصي.
ولم يكترثْ بنشازِ مغنيّة من شمال أوديسا تغني هللويا
لزوّار شارعِ أرْبات،
فيما أغاظته كوفيّةٌ حَرَستْ وردتينِ على صدرِ كنزتِها المخمليّةِ
من نُتَفِ الثلجِ.
البربريّ الّذي عادَ من رحلة الصيفِ بعد انتهاء إجازتهِ العسكريّةِ،
لم يكتشفْ أن خطّاً من الشيبِ يلهث في رأسِ زوجتِه
كسبايا جيوشِ أباطرةٍ خرجتْ من بطونِ العُهودِ القديمةِ،
حتّى رآهُ الحَواريّ يصعدُ من جوفِ قلعةِ أنطونيا بغِلالةِ بيلاطس،
أو يتربّص، في الحاجز العسكريّ
بحُوصَلةِ الطيرِ،
والماءِ في باطنِ الأرضِ،
والأبدِ المطمئنِّ لرحمتنا بعدَهُ خلفَ ذاكَ الجدارِ.
وكانت عقاربُ ساعتهِ تستغيثُ على رسغِهِ،
وهو ينكشُ،
رغم العمى بالعصا التي لم تعدْ في يديهِ لسيرةِ أفعى تشقّ له البحرَ،
بطنَ الحديقة حتّى يواري خطاياهُ تلكَ.
ويسأل زوجته في الصباح: أكنتِ معي حين كنتُ هناكَ؟
كأنّي قتلتُ لأدرأ عمّن قتلتُ خطيئةَ قتلي.
وحريّتي أنّ معجزتي في مناصي.
3-
لا تعُدْ يا غريبُ
تركتُ الستائِرَ بيضاءَ في غرفتي،
والوسادةَ،
والكأسَ بيضاءَ مِنْ غيرِ ماءٍ،
وحبرَ الوصيّةِ مُندلِقاً مثل ضوءٍ عجوزٍ على جبهتي،
وغطاءَ السريرِ الذي نِمتَ فيه ثلاثَ ليالٍ سويّا.
وسبّابتي، بعدَ أن رفعتْ بيْ الشهادة َ، مثلَ وليمةِ سطْوٍ،
على جنباتِ زِنادِ المسدّس بيضاءَ أيضاً.
وهذا الظلامُ يحّدقُ بي.
لم يعُدْ أيّ شيءٍ هنا يشبِهُ أيّ شيءٍ هناكَ.
كأنّ يديْ ظلّ شاهدةٍ لِسِوايَ،
لعلّي سمعتُ اسمَهُ بينَ حربينِ
في سِيرِ الذاهبينَ إلى حَتفِهمْ عنوةً،
أو قرأتُ اسمَهُ في قوائمِ قتلى الوباءِ الأخيرِ،
وعينيّ عينَا غُرابٍ كَسِيحٍ على رأسِ تمثالِ غوته
يُلاحِقُ آخرَ ريشاتِهِ
في الدخانِ المبلّلِ باللعَناتِ على عتباتِ الجحيمِ.
كأنّي على جبلٍ لا أكلّمُ نفسيَ،
فيما تقيمُ الشعوبُ القديمةُ في لغتي،
والفلاسفةُ العارفونَ بنَسْلِ الطبيعة ِوالكائناتِ،
وآلهةُ الأممِ المطمئنّةِ للحبَ ينبتُ في صلواتي،
وينمو كحقلَيْ سنابلَ بين ذِراعيّ،
واللاجئونَ إليّ بموتِ الزهورِ على الشرُفاتِ،
وموتى بلا رحمةٍ فقدوا دمَهمْ في مدُنٍ متعفّنةٍ،
وشفاهٍ لم تعدْ تستطيعُ الهبوطَ إلى النهرِ
حتّى تقلّدَ ثيرانَ إشبيليا قبلَ بدءِ مصارعةٍ
تنتهي بتبادلِ قبّعةِ الماتادورَ.
أنا ملحُ أرضٍ مُباركةٍ خانَهُ الأقربونَ،
وأفسدَها العابرونَ،
وأوصى بها الفاتحونَ لغيري،
أسيرُ وحيداً،
وتتبعُ صوتي البحارُ، وسورُ المدينةٍ،
والهندباءُ التي نبتتْ في أهازيجِ بحّارةٍ لم يعودوا،
وليسَ سوى شجرٍ ميّتٍ
في مخيلَةِ الغرباء الَّذين أقاموا على جنَباتِ سريري،
وغرقى يئنّون تحت وسائدهمْ.
لستُ أحتاجُ هذا القناعَ لأعترفَ الآنَ أنّي حقيقةُ أمري،
وليسَ بمقدورِ قاتليَ المتمرّسِ أنْ يحجبَ الضوءَ عن فكرتي.
ما صعدتُ على الطودِ كي يصطفيني إلهي على الكائناتِ،
ولم أبنِ لي هيكلاً
لأصلّي على من أضاعوا شواهدهُمْ في قبورٍ جماعيةٍ،
أو حروب تجوسُ خلالَ الديارِ،
وتسبي بلا رحمةٍ في طريقِ الخروجِ إليّ مزاميرَ شعبي،
ولم آتِ في سِيَرِ الأوّلين بتاجٍ من الشوكِ فوق جبيني
سوى كي أقومَ،
وأصرخَ في سِفرِ من شاءَني ميّتاً في الأساطيرِ؛
يا خالقي في السماواتِ!
شكراً لأنّيَ مازلتُ حيّاً.
4-
أنا تائهٌ في الحبّ
أجمعُ في يديكِ ملامحي
وتَفقّدي لأصابعي.
مازالَ وجهُكِ من وراءِ حجابكِ الكحليّ
مثلَ الضوءِ في ماءِ الغديرِ،
وبينما آثارُ خطوتِيَ الأخيرةِ ما تزالُ تشيخُ على الرمالِ،
ورغوةُ الموجِ الّتي ضَلّتْ إليّ طريقَها
كفّتْ على قدميّ كالعشبِ الغريبِ عن النمُوّ.
لوْ لم أكنْ كالنهرِ أقدِرُ ما أشاءُ على التدفّقِ
لم أصاحبْ نجمةَ الميعادِ،
والأشجارَ،
والغيمَ المعافى في مُخيّلةِ البحيرةِ،
والقوافلَ كلّما انقلبتْ على أعقابِهَا،
وأبناءَ آوى في الصحاري.
لو أستطيعُ لما سقطتُ، لترتوي بيْ الأرضُ، من هذا العلُوّ.
5-
ماذا تبقّى مِن عواصِفكِ الّتي ذرّتْ مصابيحِي الأخيرة َ
في زُجاجِ الشرفةِ المكسور ِ؟
لمْ تَرِثِي منَ الضوءِ الّذي، بِتَمَهّلِ الأعمى، تأخّرَ في الصباحِ
سوى حُطامي.
لم تعُدْ تأتي إليكِ روائحُ النعناعِ والبرقوقِ مُنتصفَ الليالي،
لمْ يجِدْ أحدٌ فراشاتِ الحدائقِ
َترتقي أدراجَها، ببراعةِ اللُبلابِ، بين يديكِ،
ولم تعدْ تأوي إليك البئرُ والدفلى الّتي كانتْ تجيءُ معي
لنذكُرَ للبحارِ بأنّ جسمَكِ في المساءِ مصبّ نهرٍ،
بينما عيناكِ مثل تُويْجَتَينِ نديّتينِ تغنّيانِ الغيمَ للحطّابِ.
ما عادتْ لهذي النارِ ألسنةٌ تطهّرُنا من الماضي المؤجّلِ،
ذاكَ أنّكِ تُشبهين المعبدَ المهجورَ،
فيما أشبهُ فميَ المُدمّى في كلامي.
6-
لا أزال أحبّكِ
بين المرايا الّتي هرمتْ
في بيوتٍ تباغِتُها الحربُ فيما يدوّنُهُ العابرونَ،
وبعضُ الرواةِ،
ومُغتَنِمو الفُرصِ الضائعةْ.
مثلَ ريحٍ على عجَلٍ تتعثّر بالسروِ فوقَ التلالِ البعيدةِ،
كنتُ أجيئكِ
بالقبّراتِ التي داهمَتْني،
وخوفِ النجوم التي سقطتْ في الغديرِ بلا أثَر ٍ،
كلّما التفتتْ لي يداكِ،
وكنتِ بنشوةِ سُنبلةٍ تُنضِجينَ ظلالكِ
بين السواقي الَتي لم تعدْ تقتفي خُطوتي،
و المراسي التي صَدِئت في مرافئ
ما زلتُ فيها غريباً
كأجراسِ طيفي الّتي غرقتْ في دموعِكِ.
ليسَ ضبابُ الرحيلِ الّذي اسْودّ في دمِنا فجأةً،
لا ارتباكُ الشفاهِ التي علقتْ في شِباك الجفافِ،
ولا أنّةُ الحلْمِ حينَ نفيقُ على غفلةٍ من أصابِعِنا في سريرينِ
في بلدَينِ غريبينِ،
بلْ لم يعدْ أحدٌ ما يرانا نُطيلُ العناقَ
قريباً من الديرِ في الليلةِ السابعةْ.
7-
يدُكِ التي كبُرتْ، كضوءٍ ينقرُ الشبّاكَ، بين أصابعي،
ترعى ممالكَ نحلِ أهلِ الشام في جسدي النحيلِ،
ورقصةَ الغجرِ الَذين بنَوا خيامَهُمُ الأخيرةَ في الطريقِ إلى بعلبكَ
تشبه ماءَ العذارى في مُخيّلةِ البداوى.
كلَما أردى بنَا العطشُ الّذي لا ينتهي ورثَتْ ينابيعاً تفجّرُ في الخلايا
خبطَ عُرجونٍ قديمٍ قد هوى.
لمْ ينتبِهْ أحدٌ سوايَ
إلى ظلالِ فراشةٍ عادتْ لتغفو
، مثل أقداري التي تاهتْ كسهمٍ طائشٍ من قوسِكِ الوثنيّ،
بينَ خطوطِها.
يدُكِ الّتي ركضتْ، لتلحقَ بي، أمامَ البحرِ
فارتطمتْ بصخرِ الشاطئِ المهجورِ،
لمْ أعثُرْ عليها في المنافي.
لمْ أعدْ ذاكَ
الّذي
ما ضلّ عنكِ ِ
وما غوى.
8-
والنهرُ أيضاً يدّعي، مثلَ الغمامةِ، أنّهُ يمشي وراءكِ
، هائماً، نحو الغديرِ،
وتهمسُ الغاباتُ للريحِ الّتي وقفتْ على عَتَباتِ بيتكِ، مثلَ ظلّي،
أنّ صوتَكِ يشبهُ أن تختلي صفصافةٌ بحفيفِهَا،
وتصدّق الأمواجُ أنّكِ أنتِ من أهديتِ أجنحةً لأسرابِ النوارسِ.
غيرَ أنّك لم تتفقّدي جسدي الّذي يعوي
، كتمثالٍ وحيدٍ في الحديقةِ، مُوحِشاً،
ودمي الذي أوْرَثتِهِ ألمَ الوُعولِ،
وخيبةَ الأصدافِ في زبدِ البحارِ المعتمةْ.
عِشرونَ عاماً
أعبرُ الأمواجَ،
والأضواءَ في المدن الغريبةِ،
والدروبَ المستباحةَ بين وادي النملِ والآبارِ
في أطرافِ مملكةِ الهداهدِ،
والرواياتِ الّتي اتسعتْ لحادثةِ انتحاري بينَ هاويتينِ،
والأملَ المخاتلَ في وصايا قارئاتِ الكفّ،
حتّى أقتفي أثري الَذي ضيّعتُ في عينيكِ.
لم تعثُرْ عليكِ سوى المرايا النائمةْ.
9-
ماذا يخبّئُ لي هذا العناقُ وقوفاً،
الطويلُ كضوءٍ ساقطٍ من سماءِ غابةٍ تحتَ خطّ الاستواءِ،
الحزينُ مثل وردةٍ فقدت ْرحيقَها في الرياحِ الموسميّةِ؟
صوتُكِ الممزٌقُ يرغو في دمي كحديثٍ مهمل ٍ
في زوايا الغرفةِ الموحشةْ.
وقميصُكِ المبلّلُ بالآهاتِ يعلو على صدري ويهبطُ بي
كريشةٍ في فمِ الدخانِ،
فيما الشمعُ، أعمى كعُزلةِ العناكبِ في مرعى،
يَسِحّ على ظلّي،
وتلهو بأعضائي أظافِرُكِ العمياءُ. ُ
لوْ أنَني ما زلتُ ساقيةً لما توقّفتُ عن غسلِ الخطايا،
لوَانّ الحبّ ملكُ يديْ البيضاءِ
ما خابِ ظنّ العاشقينَ بما ظنّوا بِمَنْ عشقوا،
لوْ أنَ لي قلباً سوى هذا.
أنا كومَةٌ تَحُتّها الريحُ من حجارةٍ
لكي تعبُري ماضيكِ نحوي.
اذكُري اسْمي ولو مرّةً حتّى أصدّق قلبي،
أنّ عينيكِ هذا الصيفَ قد تعثُرانِ بي،
وجسمَكِ يصحو في الشتاءِ مثلَ أغنيةٍ ريفيّةٍ
في سريري.
ليتَ قلبيَ هذا ليس لي.
ليتُهُ لي
كي أعودَ إليّ، مثلما كنتُ وحدي، دونَكِ.
انتظَرَتْكِ شتلةُ الأقحوانِ في يديْ، والحقولُ
تلكَ الّتي جاءتْ معي لكي تركضي فيها،
وخيباتُ عشّاقٍ رأوا جسدي قتيلَ حبّكِ بينهمْ،
أنا من تبقّى من حطامِكِ في هذا العناق الّذي يبقى
كذاكرةٍ تشقى،
اذكري مرةً إسْمي لأغفرَ لي
أنّي شبيهُ مناديلِ الوداعِ التي تحجّرتْ في يديكِ،
بينما أنتِ تبكين سوايَ.
اذكريني بين عشّاقِكِ الّذين أعميتِهمْ بما رأوا منكِ
مِن وراءِ حجابٍ
كلّما سَكِروا.
لا تقتُلي شاعراً مثلي بما سوّلتْ أقدارُكِ الطائشةٌ.
-10-
أنا، بين حقلَيْ بنفسجَ ، نائمةٌ
، مثلَ قطرِ الندى في ظلالِ التويجاتِ،
لكنّ عينيّ ما زالتا ترقبانِ حبيبي
حبيبي الّذي لم يعدْ من وراءِ الوِهادِ البعيدةِ ،
أنضجتُ كرمي بكفيّ حتى تدفّقَ منهُ النبيذُ ليشربَ ما شاءَ،
رّبّيْتُ في بئريَ الماءَ حتّى انتشى من روائحِهِ الطيّباتِ الرعاةُ،
وحرّاسُ تلكَ القُرى النائياتِ،
ليروي كما يشتهي جذعَهُ،
وخطوطَ يديه التي ذبلتْ في غيابي،
وأطعمتُ من عسلي وحليبي قطاةً
رأتْ ظلّهُ في البلادِ الغريبةِ.
ذاكَ حبيبي الّذي لا يزالُ حبيبي
لأنفاسِهِ طعمُ غاشيةِ الجُلّنارَةِ عند الظهيرةِ حينَ يخِفّ إليّ،
وعيناهُ ينبوعانِ من الضوءِ والخمرِ.
ذاكَ حبيبي الّذي ما يزال حبيبي